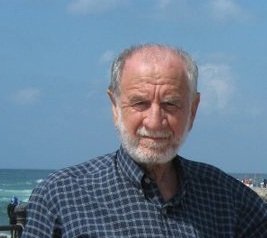دراسة أدبية
الذاكرة ذلك المعين الحيوي الذي من شأنه رفد الصورة الفنية للشخصية الروائية بمعطيات البناء، ويمنحها بريقاً يمثل مكوناتها الداخلية، ويجعل العينين تنطقان بخباياها وتحرض الأسئلة لدى الآخرين على التنقيب فيهما، الذاكرة هي الأصل حينما يتعلق الأمر بالعمل الإبداعي وخاصة الرواية، وبدونها ستميد الأرض تحت ركائز عقل القاري وهو يحاول إخراج الشخصيات المترنحة من غيبوبة الإحساس بالضياع، حتى الأمكنة في سياق ذلك تتمتع بذاكرة تكسبها عراقة وتمنحها بصمة سوف تتبدى حتى في معمارها ولغة أهلها وتراثها الشعبي الذي يشمل الملابس والعادات والتقاليد وأصناف الطعام والمقاهي والأسواق القديمة، وكل ذلك يمثل المنهل الأساسي الذي يمنح النهر الجاري هويته، والمقالع التي تزود الروائي بمادة البناء حتى تصبح للرواية شخصيتها وهي تعلن عن القضية التي تبناها المؤلف.
فكيف نفهم دور الذاكرة العميقة في بناء الرواية! دعونا نفهم ذلك..
فالذاكرة على صعيد عام تتراكم فيها الخبرات الإنسانية وعاطفتها بكل ما فيها من توترات وحنين على المدى الطويل، تعد من المكونات الأهم للشخصية الإنساني، فهي التذكر الواعي والمتعمد للمعلومات الواقعية والخبرات والمفاهيم السابقة.
وخاصة الذاكرة العرضية التي تخزن التجارب الشخصية المحددة، ناهيك عن الذاكرة الدلالية التي يناط بها تخزين المعلومات الواقعية، لذلك لا يمكن فصل معينها عن نهر الرواية الجاري في أعماق "الزمكان" وصولاً إلى بحر الحياة، لتعوم في أعماقه على اعتبار أنه كائن حي له ذاكرة مستقلة.
وقديماً كانت المعرفة تحتاج إلى بذل مجهود كبير حتى تخزن في الذاكرة كي توظف إبداعياً، وسأعود بكم إلى زمن أرسطو حيث تطرق إلى مبحثها بالتلميح في كتابه عن الروح، الذي يقارن العقل البشري بلائحة فارغة. حيث قال إن جميع البشر يولدون دون معرفة ثم تتكون المعرفة من مجموع خبراتهم.
وكأنه يفصح عن دور تراكم الخبرات في الذاكرة، ومن الطبيعي أن يرتبط ذلك بكل تفاصيل حياة الشخصية في الرواية وتجاهلها سيخرجها حتماً من سياق المعقول وبالطبع سينعكس على جوهر الأحداث التي تترابط فيها الأسباب مع المخرجات في علاقة منطقية وموضوعية
ولعل ما وضعه الفيلسوف الألماني الشاب هيرمان إبينغهاوس يعد أول نهج علمي لدراسة الذاكرة. ولاتزال بعض النتائج التي توصل إليها ذات صلة بما هي عليه اليوم، ولكن الفضل الأكبر ينسب إلى إنديل تولفينغ الذي اقترح عام 1972 التمييز بين الذاكرة العرضية والدلالية. وقد اعتمد هذا الاقتراح بسرعة وأصبح الآن مقبولاً على نطاق واسع. وبعد ذلك، في عام 1985، اقترح دانيال شاكتر تمييزا أكثر عمومية بين الذاكرة الصريحة (التصريحات) والضمنية (الإجرائية). وفقا للتطورات الأخيرة في تقنية التصوير العصبي؛ فكان هناك العديد من النتائج التي تربط مناطق محددة من الدماغ بالذاكرة التصريحية. فما صلة هذه المقدمة بالبناء الروائي من حيث توظيف الذاكرة في سرد الأحداث، والتنقيب على جذور الشخصيات في صناديقها، والاعتماد عليها حتى في الأزياء والأطعمة والتمايز في العادات التقليدية والمكتسبة بين الشخوص، وإسقاط القضايا من الذاكرة السياسية على الظروف التي تتحرك في بوتقتها الشخصيات النامية، حتى يصبح لتفاعلهم في الحدث العام مبرراً، فلا يقحموا دون هدف.
إن الدور الوظيفي للذاكرة يقوم على ثلاثة أنواع وهي:
1- الذاكرة العرضية
تتكون الذاكرة العرضية من "تخزين وتذكر المعلومات الرصدية التي تتعلق بأحداث معينة في الحياة، حيث يمكن أن تكون ذكريات حدثت لموضوع معين أو مجرد ذكريات لأحداث وقعت حولهم، كما أن الرحلة العقلية هي إعادة مختلف التفاصيل السياقية والظرفية للتجارب السابقة"(1).
فمثلاً توصيف حادثة دخول بطل الرواية لموقف صادم يكون من شأنه أن يغير من مواقفه السياسة باتجاه ما، ولنفترص أنه صحفي إسرائيلي ذهب ليغطي نتائج الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، فلو كان هذا الصحفي منتدب من قبل صحيفة إسرائيلية فإن الكاتب سيبرر تغيير سلوك هذه الشخصية نحو دعم حقوق الإنسان وإدانة المعتدي، وهذا ممكن ومقبول، ولكن، ومن جهة أخرى، سيفهم موقفه أيضاً في سياق الأحداث المرتبطة بالذاكرة العرضية لو تجمس الصحفي لسياسة القتل التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وفق رؤيته الصهيونية من أجل حسم المعركة لصالح بلاده، فهو يعلم بأنه ينتمي لدولة احتلال، لكن ذاكرته المزدحمة بالرسائل الصهيونية ستشوه له الحقائق، وستضعه في منطقة الدفاع عن النفس، ولا ريب سيقاتل لأجل ذلك.
كما تتضمن الذاكرة العرضية بعض الأمثلة مثل ذاكرة دخول السوق القديم للمرة الأولى وذاكرة شراء سيارة بالدين وعلاقتها بتغيير الظروف الحياتية، حيث سيتذكرها المعني خلال تفاصيل حياته لارتباط الصفقة بالقروض المرهقة، كذلك ذاكرة إعلامك بأنه تم طردك من عملك، أو ملامح الشخص الذي أبلغك بالقرار. ويمكن التفكير في استرجاع هذه الذكريات العرضية على أنها عمل من إعادة التأهيل العقلي بالتفصيل للأحداث الماضية حيث يعتقد بأن الذاكرة العرضية هي النظام الذي يوفر الدعم الأساسي للذاكرة الدلالية.
2- الذاكرة الدلالية
وتعود إلى المعرفة العالمية العامة حيث أنها "مستقلة عن التجربة الشخصية. وهذا يشمل المعرفة العالمية ومعرفة الكائن والمعرفة اللغوية والتفكير المفاهيمي. يمكننا أن نتعلم عن المفاهيم الجديدة من خلال تطبيق معرفتنا المستفادة من الأشياء الماضية"(2). وتشمل الأمثلة الأخرى للذاكرة الدلالية أنواع الكتابة ودلالاتها وتصنيفاتها بناءً على ما الأسلوب والمفردات التي تتلاءم ونوعية المناسبة، وهذا يدخل في صلب تعدد الأساليب في البناء الروائي وزخرفة الواجهة بالمحسنات اللغوية والصور الجميلة وتوظيف كل ذلك في الكشف عن التفاصيل بالتدريج من خلال عنصر التشويق؛ لأن الذاكرة الدلالية لها علاقة بالأنظمة ومحدداتها الوصفية، بالإضافة إلى محتويات المعاجم والموسوعات من الناحية الوظيفية.. فهي تزود الراوي بالمعلومات العامة للأمكنة ووصف الظروف البيئية التي سيشقها نهر الأحداث في مسيرته خلالها ويحمل من طبيعتها ما يصدر من ازدحام الحياة فيها، أو من عبق حدائقا على ضفتيه..
3- الذاكرة المكانية
تعد الذاكرة المكانية "جزء من الذاكرة المسؤولة عن تسجيل المعلومات حول بيئة الشخص وتوجهه المكاني. على سبيل المثال، فإن الذاكرة المكانية للشخص مطلوبة للتنقل في أنحاء مدينة يكثر التردد إليها"(3) أو يعيش فيها تفاصيل حياته، ففي روايتي "صخرة نيرموندا"(4) التي صدرت عام 2016 كانت يافا قبل نكبة فلسطين حاضرة في كل التفاصيل لأنها مثلت شخصية الأم والحبيبة والبيت والناس والأمل والحضارة، هذا قبل طرد أبنائها إلى المنافي، لذلك حينما يتجول بطل هذه الرواية في الذاكرة المكانية المنهوبة فيستلزم الأمر من الروائي البحث عن أدوات البناء الفنية اللازمة لإعادة بناء مدينة طمست ملامحها ومن ثم التعامل معها ككائن حي، كي يشاطر بقية ابطال الرواية صراعاتهم مع المستجدات، فالمدن تنمو في الذاكرة الخصبة وقد تدمرها فوبيا الخوف من السلطات، ولكنها في الذاكرة الجمعية تظل حية لا تموت، وعلى هذا الأساس تعاملت مع هذه الذاكرة المكانية "يافا" لبطل الرواية "سعد الخبايا" .
ولعل الذاكرة المكانية تتجلى أكثر في رائعة الكاتب أمين معلوف رواية "صخرة طانيوس" التي نشرت ترجمتها العربية عام 1993.
الرواية تعاملت مع الأمكنة بحميمية خاصة لأنها كتبت منسوجة من الذاكرة، وكان الراوي يعيد سرد الحكاية بتفاصيلها الزمكانية، متكئاً إلى حدٍّ كبير على الذاكرة بكل مستوياتها، وكان يقصد بصخرة طانيوس ذلك المعلم الموجود في بيروت ويشير إليها.
وتحكي رواية "صخرة طانيوس"(5) قصة طانيوس ذاك الفتى المسيحي، ابن لميا، المرأة فائقة الجمال. تدور الإشاعات حول هوية والده الحقيقي. وتدور أحداث الرواية في ضيعة كْفَرْيَقْدا (الاسم الأصليّ لـ "عين القبو" ضيعة أمين معلوف من قرى المتن الأعلى في لبنان). كما تصور الرواية صراع القوى الكبرى (الإمبراطورية العثمانية ومصر وانكلترا) في منتصف القرن التاسع عشر للسيطرة على الجبل اللبناني. يقول المؤلف: "إن هذه الرواية مستوحاة بتصرف من قصة حقيقية، اغتيال البطريرك الماروني في القرن 19 على يد شخص معروف باسم أبو كشك معلوف، وكان القاتل قد لجأ إلى قبرص، فأعيد إلى البلاد بحيلة من أحد عملاء الأمير ثم أعدم".
وتجدر الإشارة في سياق ذلك إلى أن الذاكرة المكانية وخرائطها تعمل في كل من الذاكرة قصيرة المدى، والذاكرة طويلة المدى. وتشير الأبحاث إلى أن هناك مناطق محددة من الدماغ مرتبطة بالذاكرة المكانية. وتستخدم العديد من الطرق لقياس الذاكرة المكانية لدى الأطفال والبالغين والحيوانات، وهذا بدوره يجب أن يؤخذ بالحسبان أثناء بناء الشخصيات وبالتالي بلورة علاقتها بالبعد النفسي، فمثلاً عند إصابة شخص ما بفوبيا الأماكن المرتفعة فإن للذاكرة المكانية دور في ربط الحالة بها والبحث عن علاج يخفف من وطأة الحالة عليه أو التنقيب عن دلائل تشير إلى المسببات فيما لو أصيب الشخص بضرر ما.
3- ذاكرة السيرة الذاتية
"هي نظام ذاكرة يتكون من مقاطع من حياة الفرد وذلك بناءً على مزيج من الذاكرة العرضية (تجارب شخصية وأشياء معينة وأشخاص وأحداث تمر في وقت ومكان معينين) والذاكرة الدلالية (معرفة عامة وحقائق حول العالم)"(5). ومن الطبيعي أن يعتني الكاتب بكل تفاصيل هذه الشخصية الحياتية من حيث ما تواجهه من صراعات، أو تشقه من طرق نح المستقبل، وما يظل من طموحاتها حبيس الأحلام، ولعل ما هو أهم ما يتعلق بجذور الشخصية الثقافية والنفسية والمذهبية والعاطفية المرتبطة بالذاكرة الاسترجاعية من خلال ما يسده الرواة في سياق السرد، أو ما يبوح به من خلال لغة تيار الشعور، هذه اللغة التي اشتهر بها الكاتب الأمريكي فوكنر.
إذن فالذاكرة عنصر أساسي في بناء مداميك الرواية وتشكيلها الجمالي وزخارفها اللغوية المحملة بالصور الفنية الساحرة، وتحديد كتلها ذات البنية المستقرة بما يتلاءم مع قواعد كتابة الرواية وعناصرها الفنية التي تتألف من الشخصيات والزمان والمكان والحدث والعقدة والخاتمة الحل، وبدونها ستتحول الرواية إلى عمل مسطح باهت لا عمق فيه.. فالرواية بناء ينسجم مع نسبية أينشتاين التي احتسبت مع إقليدية الأبعاد ذلك البعد الزمني الذي سيجعل من الرواية كائناً كونياً لا يموت مع الروائي، بل يرصع سماء الثقافة كالنجوم.
والذاكرة فعل استعادة لزمن ماض كوسيلة لإصلاح الحاضر والغاية فتح أبواب التعاطي مع المستقبل بوعي، وقد يكون بالعكس أي أن الروائي يهتم بالحاضر وجذوره المستمدة من الماضي لكي ينشغل بها عن التطلع إلى المستقبل.. وبذلك تغدو عملية التذكر بمثابة البوابة للانشطار الذاتي بين ماض ذاهب وحاضر راهن، وهذا يجعل حياة الشخصيات مستمرة في عالم يتغير.
إن "الذاكرة كبناء فاعلي تخزيني وذخائري لها مرجعيات تؤطر الشكلية التي تتخذها فقد تكون الذاكرة سياسية أو اجتماعية أو تاريخية أو أدبية وهذه الأخيرة تفترض وجود البعدين الواقعي والافتراضي لكي تؤدي وظيفتها الفنية داخل السرد على وفق الوعي باللحظة الراهنة للحاضر وهذا الوعي يظل في حركته جاريا ولا تحدده أفكار تعسفية عن الزمن" (6)
ولكن للأسف إذ يرى بعض النقاد الأكاديميين في أن نفض الذاكرة والتنقيب فيها ومن ثم توظيف معطياتها في كتابة الرواية، ما هو إلى استسلام للماضي وتحنيط للشخصيات، ولقلة خبرتهم وربما لأنهم لم ينتجوا أدباً إبداعيا وظلوا متقوقعين بين نظريات النقد دون تفهم لمعطيات التحليق فوقها، فهم لا يدركون بأن حتى للمدن ذاكرة، وأن معالمها القديمة تمثل ملامحها، فماذا حينما يتعلق الأمر بالشخصيات التي تشارك في صنع الأحداث في الرواية أو تتأثر بها، حسب دورها المناط بها وفق مقتضيات الحدث، فمن خلال الذاكرة سيحصل القارئ الحصيف على مفاتيح الشخصية، وأسرار المدن وما حل بها، ناهيك عن كونها تمثل إحدى مكونات اللاوعي، والتنقيب فيها يساعد على فهم أبطال الرواية وإعادة برمجتهم ليواكبوا سير الأحداث وفق رؤية الكاتب حيث أن لتطورات الأحداث أسباب لها في الماضي ولم تأت اعتباطاً في نص يحترم عقل القارئ.
وفي الحقيقة يمكننا القول "إن ما تعنى به الذاكرة الروائية ليس نقد الخطاب بل نقد المؤسسة والطبقية من دون الوقوع في حبائلها فهي ثائرة على الشعور بالدونية وهذا ما يعبر عنه بنقطة الحضور او الأصل الثابت اللذين يشيران الى المركز"(7).
وقد يشطح الخيال بالمبدع للتخلص من أثر الماضي وبناء حلم جديد وفق رؤيته؛ ولكن عليه أيضاً ألا يبتعد عن الأرض حتى ولو انتقل الزمكان بالنص إلى غياهب الفضاء، ما دامت الرؤية تستهدف الإنسان، في حين أن الذاكرة لا بد وتكون حاضرة ولو في عصف من الأسئلة حتى ترتبط الشخصيات بجذورها ولو كانت مبهمة. ففي الذاكرة توجد العاطفة وبدونها تتحول الشخصية إلى آلة مسيرة لا مخيرة، تتحاذف أخبارها ألسنة رواة بلهاء، وقد قطعوا الطريق على ما يتدفق من أعماق الشخصية من خلال تيار الوعي. وكأن هذا الناقد لم يقرأ لعمالقة الرواية عبر تاريخ الأدب.
إن الذاكرة وما يتداعى من أعماقها ستمنح الكاتب لو أحسن توظيفها القدرة على بناء الرواية وابتداع الزخارف التي تغطي واجهتها المعمارية والمستوحاة من التركيبة الجينية التي تختلط فيها مكونات الكاتب الفكرية والإنسانية وهمومه وقضاياه، لإغراء القارئ إلى طرق بابها حتى يعوم في تفاصيل الرواية فلا يخرج منها إلا وتحدوه الرغبة لإعادة اكتشاف ما فاته منها، ومع التكرار ستتحول الرواية إلى صديق لا غنى عنه فيوفق الكاتب في إيصال رسالته إلى الناس.. وتتشكل دمغته على وعي القارئ.. فالذاكرة تعد فيما لو وظفت جيداً، أجمل ما في الرواية، والتخلص منها يحول الشخصيات إلى بيادق، أو قوالب ثلج يصنعها المؤلف بناءً على رغبات النقاد التي في بعضها ما يعبر عن أمراض نفسية هدامة نابعة من مرتب نقص.. لأن الناقد الحقيقي يتعامل مع النص ككائن حي له حقوقه فيتم التعامل معه بروح النظرية النقدية وليس بسيف الجلاد!
الذاكرة في اللاوعي تحتوي على العاطفة التي تمثل المرجل في الرواية حيث تغلي الأحداث وتحدث المتغيرات، وتتصاعد الأبخرة.
يجب ألا يكتفي الناقد الأكاديمي بالتمترس خلف النظريات المنحوتة التي تحاصر مجريات النص في السدود، بل عليهم أن يتفهم لغة الشلال ومنحنيات الطريق وما تخبئه الأعماق من درر.. ويتعامل مع النصوص ككائنات حية منفصلة ويستخرج معطياته النقدية من أعماقها، إلا ما يتعلق بعناصر الرواية الأساسية التي بدونها ستكون الرواية مصابة بشلل نصفي.
![]() من ألمانيا لإسبانيا .. رحلة تمثال فرعوني استقر بقبضة تاجر تحف
من ألمانيا لإسبانيا .. رحلة تمثال فرعوني استقر بقبضة تاجر تحف![]() استخدامات الميزوثيرابي ديرما بن
استخدامات الميزوثيرابي ديرما بن![]() الأمير وليام يستأنف أنشطته بعد إصابة كيت بالسرطان
الأمير وليام يستأنف أنشطته بعد إصابة كيت بالسرطان![]() مصرفي مصري بالإمارات ينقذ عائلة من الغرق داخل السيارة
مصرفي مصري بالإمارات ينقذ عائلة من الغرق داخل السيارة![]() ماسك: جميع وسائل النقل ستصبح كهربائية مع مرور الوقت
ماسك: جميع وسائل النقل ستصبح كهربائية مع مرور الوقت![]() طعام خارق يسيطر على ارتفاع ضغط الدم
طعام خارق يسيطر على ارتفاع ضغط الدم![]() السبب الحقيقي وراء انقطاع خدمات Meta المستمر
السبب الحقيقي وراء انقطاع خدمات Meta المستمر![]() الاحتلال يفرج عن أسير فقد نصف وزنه
الاحتلال يفرج عن أسير فقد نصف وزنه![]() الصفدي لنظيره الإيراني: لا أحد يستطيع أن يزاود على مواقف الأردن
الصفدي لنظيره الإيراني: لا أحد يستطيع أن يزاود على مواقف الأردن![]() حماس تؤكد مساع الاحتلال الخبيثة لاستبدال الأونروا
حماس تؤكد مساع الاحتلال الخبيثة لاستبدال الأونروا![]() الأردن يشارك بالاحتفال بيوم التراث العالمي
الأردن يشارك بالاحتفال بيوم التراث العالمي![]() الأردن يوسع المستشفى الميداني نابلس/2 لتزايد أعداد المراجعين
الأردن يوسع المستشفى الميداني نابلس/2 لتزايد أعداد المراجعين![]() عشيرة بني هاني تصدر بياناً بحق المجرم عمر بني هاني .. تفاصيل
عشيرة بني هاني تصدر بياناً بحق المجرم عمر بني هاني .. تفاصيل![]() فصل الكهرباء من 9:30 صباحا حتى 3 عن هذه المناطق .. أسماء
فصل الكهرباء من 9:30 صباحا حتى 3 عن هذه المناطق .. أسماء![]() سرقة الكهرباء مشمولة بالعفو العام
سرقة الكهرباء مشمولة بالعفو العام![]() مدعوون للتعيين ووظائف بجامعات وبلديات ومستشفيات والتلفزيون .. تفاصيل
مدعوون للتعيين ووظائف بجامعات وبلديات ومستشفيات والتلفزيون .. تفاصيل![]() بلدة أردنية تُعرف بمدينة الفلاسفة والشعراء .. صور
بلدة أردنية تُعرف بمدينة الفلاسفة والشعراء .. صور![]() مهم للأردنيين للراغبين بالحصول على تأشيرة إلى أميركا
مهم للأردنيين للراغبين بالحصول على تأشيرة إلى أميركا![]() كاتب أردني:قاطعوا قناة المملكة
كاتب أردني:قاطعوا قناة المملكة![]() 19 ألف دينار أعلى راتب تقاعدي في تاريخ الضمان
19 ألف دينار أعلى راتب تقاعدي في تاريخ الضمان![]() 5 موظفين في التربية فقدوا وظيفتهم .. أسماء
5 موظفين في التربية فقدوا وظيفتهم .. أسماء![]() إمهال متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم .. أسماء
إمهال متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم .. أسماء ![]() صاروخ إيراني سقط في البحر الميت .. صور وفيديو
صاروخ إيراني سقط في البحر الميت .. صور وفيديو![]() خدشت الحياء وأهانت الرجال .. تحرك رسمي ضد فتاة المواعدة العمياء
خدشت الحياء وأهانت الرجال .. تحرك رسمي ضد فتاة المواعدة العمياء![]() ماذا قال اللواء فايز الدويري عن الهجوم الايراني على اسرائيل
ماذا قال اللواء فايز الدويري عن الهجوم الايراني على اسرائيل